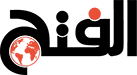الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
فالعنف والتطرف نوعان شهدهما المجتمع الإنساني منذ قديم الزمان، وتأتي قصة ابني آدم عليه السلام هابيل وقابيل أول قصة تمثل كيف يصل العنف والتطرف تجاه أمر من الأمور إلى حد القتل، حينما قدّم قابيل وهابيل قربانًا فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل فدفعه هذا الأمر إلى أن يتطرف ويصرخ في وجه أخيه هابيل قائلًا: " لأقتلنك "قال تعالى: {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آَدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآَخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} هذه القصة التي وردت في القرآن الكريم تؤكد أن العنف والتطرف مرتبطان بالنفس الإنسانية حينما تخرج عن الاعتدال والوسطية إلى الانحراف وفكر التخلص من الآخر.
ومنذ ذلك التاريخ ونحن نشهد كيف أن الفكر المتطرف كان سببًا للكثير من الفتن والقلاقل التي تهدم البنيان الاجتماعي وتنزع عنه وحدته المتماسكة وتجعله يعيش في جو من الفتن والاضطراب.
ويعد العنف من الأمور الطارئة في حياة الأمم والشعوب والتي يؤثر وجود العنف فيها على الاستقرار والأمن في المجتمع، وهناك فرق بين العنف كظاهرة طارئة والعنف كثقافة مجتمع وكلاهما خطر بلا شك وإن كان النوع الثاني أشد خطرا، ولتحقيق تماسك بنيان المجتمع وضمان أمنه لا بد من السعي إلى القضاء على العنف أو التقليل منه، ولقد بحث الكثيرون في (ظاهرة العنف) واجتهد من اجتهد في تشخيص الداء، وفي وصف الدواء، ولا بد أن نعلم أن العنف الذي تمارسه بعض الجماعات، التي تنسب للإسلام، إنما هو إفراز لفلسفة معينة، تتبناها هذه الجماعات، وثمرة لفقه خاص له مفاهيمه، وهو في الحقيقة عبارة عن خلل فكرى وعلمي.
والسؤال كيف يتم مواجهة هذا العنف؟
أولا - المواجهة الفكرية فالخلل الفكري لا يواجه بالسجون والتعذيب والتنكيل، فإن هذا قد لا يزيدهم إلا تشددا وتعصبا لأفكارهم؛ فالمواجهة الأمنية لا تكفي هنا، بل لا بد من مواجهة فكرية علمية معهم، يقوم بها رجال ثقات في علمهم، ثقات في دينهم، فإن الذي يتعمق في واقع هذه الجماعات الإسلامية التي اتخذت العنف سبيلا لها يجد بوضوح: أن وراءها أسبابا فكرية هي الأكبر تأثيرا وهي التي دفعت هؤلاء الشباب اليوم إلى ما اندفع إليه أسلافهم من قبل من الخوارج، الذين عُرِفوا بأنهم كانوا صوّاما قوّاما قرّاءً للقرآن، ومع هذا استحلّوا دماء المسلمين من غيرهم، إذ كانت آفتهم في عقولهم وأفهامهم. وقد بعث علي رضي الله عنه إلى الخوارج الذين ثاروا عليه عبد الله بن عباس، حبر الأمة، وترجمان القرآن، ليحاجهم ويحاورهم، وما زال يحاورهم ويجادلهم بالحجة والإقناع، حتى رجع منهم عدد كثير، وبقي بعضهم مصرين على باطلهم.
ثانيا - إصلاح السياسة الداخلية: لا شك أنّ تشديد العقوبة لا يؤدي إلى القضاء على ظاهرة العنف المجتمعي بأشكالها المختلفة دون أن يصاحب ذلك تحقيق العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن وإقامة النظام الاقتصادي والتكافلي الذي يحقق العدالة الاجتماعية التي أولاها الإسلام عنايته الفائقة، وهذا التكافل يقوم على أساسين هامَّين، المجتمع كله، والدولة التي تمثل ذلك المجتمع، وفي القرآن الكريم نصوص كثيرة تدل على هذا، ولا بد أن نعلم أن العدالة الاجتماعية لا بد أن تنبثق في المجتمع من تصور اعتقادي شامل يرد الأمر كله لله ويقبل عن رضى وعن طواعية ما يقضي به الله من عدالة في التوزيع، ومن تكافل بين الجميع ثم تطبيق صحيح للقانون الموافق لشرع الله تعالى من خلال القضاء العادل، أما الشعور بعدم الثقة بالقضاء فإنه يولد رد فعل سلبي مما يدفع كثير من الأشخاص إلى الرجوع لعادة الثأر واستيفاء الحق بالذات أو بطرق غير مشروعة، وهذا يولد العنف بسبب القهر والشعور بالظلم، فمن المعلوم أنه يقع على عاتق الدولة بمفهومها الحديث عبء تحقيق العدالة بين الأفراد وإعمال القانون في الواقع الاجتماعي وحمايته، وأصبحت هذه المهمة وظيفة من أهم وظائفها، ومظهرًا من مظاهر سيادتها ونشاطا أساسيا لإحدى السلطات الثلاث التابعة لها وهي السلطة القضائية.
إن استمرار العنف الجماعي والمظاهر المصاحبة له والتمادي على القانون والاعتداء على الآخرين، يؤدي إلى تراجع سلطة القانون ويؤثر في هيبة الدولة التي هي مصلحة أساسية للجميع.
أما أن ينحصر العلاج في تشديد العقوبات وتوسيع دائرة الاشتباه وكثرة الاعتقالات وفتح أبواب السجون على مصراعيها وإلصاق التهم بالبعض فهذا فيه نوع من الظلم ويؤدى إلى مزيد من العنف والتطرف وإلى التنفير من حالة الوسطية والاعتدال والعدل إلى حالة التشدد والتطرف، فلابد من مواجهة العنف بما ذكرنا للحفاظ على كيان الدولة ومصلحة الأفراد والله المستعان.