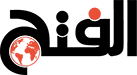هناك معنى آخر يزيل التعارض في
الذهن بين رحمة الإسلام وبين مفاهيم الولاء والبراء؛ ألا وهو أمر الله وأمر رسوله
صلى الله عليه وسلم بالبر والإحسان والعدل مع كل مَن لم يقاتل المسلمين أو يُظاهر
على قتالهم، بل حتى المقاتل يجوز بِرُّهُ والإحسان إليه إذا لم يقوِّه ذلك على
قتال المسلمين وأذاهم.
قال الله تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ
اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى
إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ). (الممتحنة: 8، 9).
وأمَّا العَدْل فهو فرضٌ واجبٌ على
كل أحد، حتى مَن نُبغضه بحقٍّ ممن عادانا وقاتلنا مِن الكفار، يقول الله تعالى في
ذلك: ?يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ? (المائدة: 8).
وقال تعالى: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ)(البقرة: 190).
ولذلك لا يجوز لنا أن نخون مَن خاننا؛ لأن الخيانة
والغدر ليسا مِن العدل.
قال صلى الله عليه وسلم: «أدِّ
الأمانة إلى مَن ائتمنك، ولا تَخُنْ مَن خانك»، لذلك فقد حذَّر النبيُّ صلى الله
عليه وسلم مِن دُعاء المظلوم ولو كان كافرًا، فقال صلى الله عليه وسلم: «اتقوا
دعوة المظلوم وإن كان كافرًا؛ فإنه ليس دونها حجاب».
وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين بأقوى
تأكيد، والعَدْلُ رأس كُلّ فضيلة، وقال ابن كثير: «ومِن هذا قول عبد الله بن رواحة
رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يَخْرُص على أهل خيبر ثمارَهم
وزرعهم، فأرادوا أن يَرْشُوه ليَرفُق بهم، فقال: والله لقد جئتكم مِن عند أحب
الخَلْق إليَّ، ولأنتم أبغض إليَّ مِن أعدادكم مِن القردة والخنازير، وما يحملني
حبي إياه وبغضي لكم على ألا أعدل فيكم، فقالوا: بهذا قامت السموات والأرض».
فقد يظن البعض التعارض بين هذه الأخلاق
الإسلامية السامية وبين عقيدة الولاء والبراء، ولا تعارض مطلقًا؛ فكل يخرج مِن
مشكاة واحدة: الكتاب والسنة؛ فالآيات التي أمرت بالحب والبغض والموالاة والمعاداة
على أساس التوحيد هي والآيات التي أمرت بالعدل وأداء الحقوق إلى أصحابها مِن نفس
المصدر، وهذا الفهم الدقيق هو ما عبَّر عنه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بتلك
الكلمات التي تكتب بماء الذهب، وقد يدخل هذا الظن الفاسد -أعني ظن التعارض- في بعض
الصور التي مِن جنس الإحسان والبر والتي سطرتها السيرة النبوية مثل:
1- زيارتهم إذا مرضوا ودعوتهم للدخول في
الدِّين:
قال الإمام البخاري رحمه الله في (صحيحه)
في كتاب المرضى: (باب: عيادة المشرك)، وأورد مِن طريق أنس رضي الله عنه: «أَنَّ
غُلاَمًا لِيَهُودَ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ،
فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَالَ: «أَسْلِمْ»،
فَأَسْلَمَ». (صحيح البخاري 6757).
وأورده في كتاب الجنائز بلفظ:
«كَانَ غلامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَمَرِضَ،
فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عند رَأسِهِ فَقَالَ
لَهُ: «أَسْلِمْ»، فنَظرَ إلى أبيه وهو عندَهُ، فقال له: أطِعْ أبا القَاسِم صلى
الله عليه وسلم ، فأَسْلَمَ، فخرج النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمدُ
لله الَّذي أَنْقَذَهُ مِن النَّارِ».
قال ابن حجر: «وفي الحديث جوازُ استخدام المشرك،
وعيادته إذا مرض، وفيه حُسن العهد، واستخدام الصغير، وعرض الإسلام على الصبي ...».
(الفتح 3/262).
وقال ابن بطال: «إنما يُعادُ المشرك ليُدعى إلى
الإسلام إذا رجا إجابته إليه، ألا ترى أنَّ اليهوديَّ أسلم حين عرض عليه النبيُّ
صلى الله عليه وسلم الإسلامَ، وكذلك عرض الإسلام على عمِّه أبي طالب، فلم يقض الله
له به، فأمَّا إذا لم يطمع بإسلام الكافر ولا رُجيت إنابته فلا تنبغي عيادته». (شرح
صحيح البخاري لابن بطال 9/380).
أورد معناه الحافظ ثم قال: «والذي يظهر أنَّ ذلك
يختلف باختلاف المقاصد؛ فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى، قال الماوردي: عيادة
الذِّمِّي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة». (فتح
الباري 10/125).
ويؤيد ذلك أيضًا زيارة عمِّه أبي
طالب وعرضه الإسلام عليه.
2- الدعاء لهم بالهداية والصلاح:
قال البخاري في كتاب (الأدب
المفرد) باب (إذا عطس اليهودي)، ثم أورد بإسناده عن أبي موسى رضي الله عنه قال:
«كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم: يرحمكم
الله، فكان يقول: يَهْدِيكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ».
قال المباركفوري: «ولا يقول لهم يرْحَمُكُم الله؛
لأَنَّ الرَّحْمَةَ مُخْتَصَّةٌ بِالمؤمنِينَ، بَلْ يَدْعُو لهم بما يُصْلِحُ
بَالَهُمْ من الهدايةِ وَالتَّوْفِيقِ وَالإِيمَانِ». (تحفة الأحوذي 8/12).
3- الوصية بهم للجوار:
فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه
وسلم الوصيَّةُ بالجار، وحُسن معاملته، والأمر في ذلك عام، سواء كان مسلمًا أو
يهوديًّا أو نصرانيًّا؛ روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: «مَا زَالَ جبريلُ يُوصِيني بالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ
أنَّه سَيُورِّثُه».
وقد فهم الصحابيُّ الجليل عبد الله بن عَمرو رضي
الله عنها -وهو من رواة هذا الحديث أيضًا- العموم في هذا الخبر، وأنَّ ذلك لا يختص
بالمسلم فقط، بل يتعدَّاه إلى غيره مِن أهل الكتاب؛ روى أبو داود والبخاري في (الأدب
المفرد) وغيرهما عن مجاهد قال: «كنتُ عند عبد الله بن عمرو -وغلامُه يَسلخ شاةً-
فقال: يا غلام؛ إذا فرغتَ فابْدَأ بجارِنا اليهوديِّ، فقال رجلٌ من القوم:
آليهوديَّ أصلحك الله؟! قال: سمعت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُوصي بالجار، حتى
خَشِينا أو رُؤينا أنَّه سيوَرِّثه».
قال الحافظ ابن حجر: «وَاسْمُ
الجَار يَشْمَل المسْلِمَ وَالْكَافِرَ، وَالعَابِدَ وَالْفَاسِقَ، وَالصَّدِيقَ
وَالْعَدُوَّ، وَالْغَرِيب وَالْبَلَدِيَّ، وَالنَّافِع وَالضَّارَّ، وَالْقَرِيبَ
وَالأَجْنَبِيَّ، وَالْأَقْرَب دَارًا وَالْأَبْعَدَ، وَلَهُ مَرَاتِب بَعْضهَا
أعلى مِن بعض، فَأَعْلَاهَا مَنْ اجتَمعَتْ فِيهِ الصِّفَات الْأُوَل كُلّهَا
ثُمَّ أَكْثَرهَا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلى الوَاحِد، وَعَكْسه مَن اجْتَمَعَتْ فيه
الصِّفَات الأخْرَى كَذَلِكَ، فَيُعْطى كُلٌّ حَقه بِحَسَبِ حَاله، وَقَدْ
تَتَعَارَض صفتان فأكثر فَيُرَجِّح أو يُسَاوِي، وقد حَمَلَه عبد الله بن عَمْرو -أحد
مَن روى الحديث- على العموم، فَأَمَرَ لَـمَّا ذُبِحَتْ له شاة أَنْ يُهدَى منهَا
لجاره اليهودِيِّ، أخرجه البخاريُّ في (الأدب المفرد) والتِّرمذيُّ وحَسَّنَه، وقد
ورَدتْ الإشَارة إلى ما ذَكَرْتُه في حديث مرفوع أخرجه الطَّبرانِيُّ مِن حَديث
جابر رفَعَهُ: «الجِيرَانُ ثَلاثَةٌ: جَارٌ لَهُ حَقٌّ وهو المشْرِكُ لَهُ حَقُّ
الجِوَار، وجَارٌ لهُ حَقَّانِ وهو المسلِمُ له حَقُّ الجِوَار وَحَقُّ الإسلام،
وجارٌ له ثلاثَةُ حُقُوقٍ: مُسْلِم له رَحِم لَهُ حَقُّ الجِوَار والإسلام
والرَّحِم».
4- الدُّعاء لهم
بالهداية وعدم لعنهم:
ومِن سيرته صلى الله عليه وسلم عدم لعن الكفَّار، والحرص على دعوتهم
واستقامتهم، فعن أبي هريرة قال: قيل: يا رسُول الله؛ ادْعُ عَلَى المشرِكِينَ،
قال: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً».
وأخرجه البخاري في (الأدب المفرد) وترجم له بقوله: «باب
لعن الكافر».
وأمَّا ما ورد مِن نصوص في لعن الكافر من كتاب الله وسنة
رسوله، فهي محمولة على لعن الكافر الحربيِّ الذي يؤذي المؤمنين والمؤمنات، فقد
أورد البخاري في (صحيحه) في كتاب الجهاد: (باب الدعاء على المشركين بالهزيمة
والزلزلة)، وذكر فيه أحاديث عدَّة تشتمل على الدعاء عليهم، ثم أورد بعده بباب: (باب
الدعاء للمشركين بالهدى ليتألَّفهم)، وذكر تحته حديث: «اللهمَّ اهْد دوسًا وائْتِ
بهم» قال ابن حجر: «قوله: «ليتألَّفهم» مِن تَفَقُّه المصنف؛ إشارة منه إلى الفرق
بين المقامين، وأنَّه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم، وتارة يدعو لهم؛
فالحالة الأولى حيث تشتدُّ شوكتُهم ويكثر أذاهم، كما تقدم في الأحاديث التي قبل
هذا بباب، والحالة الثانية حيث تُؤمن غائِلتُهم ويُرجى تألُّفهم، كما في قصة دَوْس
...».
قلت: بل كان مِن سيرته صلى الله عليه وسلم أن لا يفصح
باللَّعن، بل قد يردُّ على مَن ظلمه مِن غير أن يكون في لسانه فُحش ولا لعن، فقد
روى البخاريُّ ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
قالت: دخل رَهْطٌ مِن اليهُودِ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالوا:
السَّامُ علَيكُمْ. قَالت عَائشةُ: فَفَهِمْتُهَا، فقُلتُ: وعَلَيكُمُ السَّامُ
واللَّعْنَةُ، قالت: فقال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَهْلًا يا عَائشَةُ؛
إنَّ الله يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْرِ كُلِّهِ». فقلت: يا رسول الله؛ ولَمْ
تَسْمعْ ما قالوا؟ قال رسُول الله صلى الله عليه وسلم: «قد قلتُ: وعليكم».
قال الحافظ ابن حجر: «وإنَّما أطْلَقتْ عليهم اللَّعْنَةَ
إمَّا لأَنَّها كانت تَرَى جَوازَ لَعْنِ الكَافِر المعَيَّن بِاعْتبارِ الحَالة
الرَّاهِنة، لا سيما إذا صَدَرَ منه ما يَقتضِي التَّأْدِيب، وإمَّا لأنَّها
تقَدَّم لَهَا عِلْمٌ بأنَّ المذكورين يَمُوتُون على الكفر، فأَطْلَقت اللَّعْنَ
ولم تُقَيِّدهُ بالموتِ، والَّذي يَظْهَرُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
أراد أن لا يتَعَوَّدَ لسانُها بالفُحْشِ، أو أَنْكرَ عليها الإِفْرَاطَ في
السَّبِّ».
وهذا التصرُّفُ مِن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ودعاؤه
عليهم بما دَعوا هم عليه كان بعد أن تأكَّد مِن سَبِّهم له ودعائهم عليه بالموت،
فكانوا هم أحقّ بذلك.