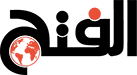من أخطر المسائل
التي تتعلق بالتكفير في مسائل المُوالاة -وبالتالي استباحة قتل النفوس-: مسألة النُّصْرَة.
وهذه المسألة من أخطر مسائل
المُوالاة، قد ذكرها الله -سبحانه وتعالى- في كتابه فقال -عزّ وجلّ-: "فَمَا لَكُمْ
فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا ۚ أَتُرِيدُونَ
أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۖ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا
وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا
مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا
فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا".
وروى ابن جرير عن ابن عباس
-رضي الله عنه- في تفسير هذه الآية قال: (ذلك أن قومًا كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام،
وكانوا يُظاهِرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجةً لهم، فقالوا: إن لقينا أصحابَ
محمد -صلى الله عليه وسلم- فليس علينا منهم بأس. وان المؤمنين لما أُخبِرو أنهم قد
خرجوا من مكة، قالت فئة من المؤمنين: اركَبوا إلى الخُبَثاء فاقتلوهم، فإنهم يُظاهِرون
عليكم عَدُوَّكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله -أو كما قالوا- أتَقتُلون
قومًا قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟! -أمن أجل أنهم لم يُهاجِروا ويتركوا ديارهم تُستحل
دماؤهم وأموالهم لذلك؟!- فكانوا كذلك فئتين، والرسول -صلى الله عليه وسلم- عندهم لا
ينهى واحدًا من الفريقين عن شيئ، فنَزَلت
"فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ" الآية).
والشاهد منها: قول المؤمنين
"فاقتُلُوهم، فإنهم يُظاهِرون عليكم عَدُوَّكم"، ونزلت في الآيات المُوافَقة
لهذه الطائفة من المؤمنين، لقوله تعالى: "وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ
ۖ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا".
قال السُدِّيّ: "إذا أظهَروا
كُفرَهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم"، وهذا أقرب ما قيل في تفسير هذه الآية، مُوافِقًا
لسياقها، كما قال ابن جرير -رحمه الله- بعد ذكر الاختلاف في من هم المقصودون بهذه الآية.
لابد أن نفرق
هنا بين من خرج مُحارِبًا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وللإسلام والمسلمين، تحت
راية الكُفْرِ المُعْلَنَة، وبين من حَكَمَت بعضُ الطوائف -أو حتى بعضُ أهل العلم-
بكُفْرِه، وهو ما زال ينتسب إلى الإسلام؛ فالدخول في طاعة الأوَّلين تنطبق عليه الآية الكريمة، بخلاف
طاعة من انتسب للإسلام؛ فإن عدم معرفة حقيقته وارِدٌ على أكثر المسلمين -أو على الأقل
كثيرٍ منهم-، فلا يمكن الحكم على من ناصَرَهم بأنه يحارب الإسلام، وأنه عدو للإسلام،
وبالتالي تُستَحَلّ منه الدماء والأموال.
قال ابن حزم -رحمه الله تعالى-:
(من لحق
بدار الكفر والحرب مُختارًا مُحارِبًا لمن يليه من المسلمين، فهو بهذا الفعل مُرْتَدٌّ،
له أحكام المرتد كلها، من وجوب القتل عليه متى قُدِرَ عليه، وإباحة ماله،
وفساخ نكاحه، وغير ذلك.. قال: وكذلك من سَكَن بأرض الهند والسند والصين والترك والسودان
والروم من المسلمين -أي وقتما كانت تحارب الإسلام والمسلمين- فإن كان لا يقدر
على الخروج من هنالك لثِقَلِ ظَهْرٍ أو لقِلَّةِ مالٍ أو لضَعْفِ جِسْمٍ أو لامتِنَاعِ
طَريقٍ فهو معذور، فإن كان هنالك مُحارِبًا للمسلمين مُعِينًا للكفار بخِدْمَةٍ
أو بكِتَابَةٍ فهو كافر، وإن كان إنما كان يقيم هنالك لدنيا يصيبُها وهو كالذِّمِّيّ لهم
وهو قادِرٌ على اللحاق بجَمهَرَة المسلمين وأرضِهم فما يَبْعُدُ عن الكُفْر، ومانرى
له عُذرًا، ونسأل الله العافية).
والمقصود بهذا
من كان عاجِزًا عن إقامة الدين في بلاد الكُفَّار دون أن يكون مُشَارِكًا بالقتال،
ولم يَحْكُم بكُفْرِه -رحمه الله-، لأنه قال إنه اقترب من الكفر
ولكن لم يدخل فيه، قال: "فما يَبْعُدُ عن الكفر"، وعدم العذر ليس في التكفير، ولكن في الإثم واستحقاق العقوبة،
لأنه عاجِزٌ عن إقامة الدين كما بَيَّنَ أهلُ العلم.
ثم قال -رحمه الله-: (وليس كذلك من سَكَنَ
في طاعة أهل الكفر من الغَالِيَة -يقصد بذلك "الباطنية" الذين عُرِفوا
في التاريخ باسم "الفاطميين" الذين كانوا يحكمون مصر والقيروان وسائر إفريقيا،
بل والحرمين والشام كذلك- ومن جرى مجراهم، كأهل مصر والقيروان وغيرهما، فالإسلام هو الظاهر،
ووُلَاتُهم على ذلك لا يُجاهِرون بالبراة من الإسلام، بل إلى الإسلام ينتمون، وإن كانوا
في حقيقة أمرهم كفارًا).
وقال أيضا: (وأما من سَكَنَ في بلدٍ تظهر فيه بعض الأهواء
المُخرِجَة إلى الكفر فهو ليس بكافر، لأن اسم الإسلام هو الظاهر هنالك على كل حال،
من التوحيد، والإقرار برسالة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والبراءة من كل دينٍ غير الإسلام،
وإقامة الصلاة، وصيام رمضان، وسائر الشرائع التي هي الإسلام والإيمان، والحمدلله رب
العالمين.) انتهى من المُحَلَّى.
فلابد من التنبه
هنا للفرق المهم بين طاعةِ ونُصْرَةِ من يُصَرِّحون بالكفر وبين طاعة من ينتسبون إلى
الإسلام وهم في حقيقة أمرهم كُفّارٌ؛
فأمر الطائفة الأخيرة يحتاج إلى نظرٍ واجتهادٍ، وليس معلومًا قطعيًا من الدين كالأَوَّلين،
وموالاتُهم وطاعتُهم وإن كانت مُحَرَّمَةً إلا أنها ليست كُفرًا يَنقِل عن الملة، مراعاةً
لهذا الفارق المُهِمّ "مالم يعلم كفرهم" فتنبه لذلك.
ومما يؤكد خطأ
ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الديارَ التي تغلب عليها الطوائفُ الخارجةُ عن الإسلامِ
-وإن كانت منتسبةً للإسلام- ديار كُفْرٍ ورِدَّةٍ: ما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مكة: "لا هِجْرَةَ
بعد الفتح، ولكن جِهادٌ ونِيَّة"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إن الإيمان
ليَأْرِزُ إلى المدينة كما تَأْرِزُ الحَيَّةْ إلى جُحْرِها"، وقال: "إن
الإيمان ليَأْرِزُ ما بين المَسْجِدَين" -أي المسجد الحرام والمسجد النبوي- كما
تَأْرِزُ الحَيَّةُ إلى جُحْرِها" وكلها أحاديث في الصحيح، تدل على أن مكة والمدينة لا تتحول إلى دار حرب إلى يوم القيامة،
إلى أن يزول من يقول في الأرض "الله الله"، والدجال
لا يدخل مكة ولا المدينة؛ فبحَمْدِ الله لا تتحول أبدًا إلى دار كفر وردة، وقد غَلَب
الباطنية الفاطميون والقرامطة على مكة والمدينة، وكان يُخطَب للحاكم بأمر
الله الفاطمي على منابر مكة والمدينة في الحرمين الشريفين -ومعلوم زندقته ونفاقه وادعاؤه
الألوهية سِرًّا-؛ فدَلَّ ذلك على ما ذكرنا من التفرقة الهامة، وعدم مساواة من يُظْهِرُ
الإسلام بمن يُظْهِرُ الكفر، فضلًا عن أن تكون الطائفة ليست حقيقتها الكفر بل هي في
الجملة تُقِرُّ بالإسلام ظاهرًا وباطنًا ويعرف ذلك من أحوالهم.
وإذا نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم بعد عصور الاحتلال،
وعجزِ كثيرٍ من البلاد المُستقلة عن أن تعود إلى ما كانت عليه قبل عصور الاحتلال، من
إقامة الشرع، وإن كانت أكثر دساتيرها تنص على مرجعية الشريعة، لكن كثيرٌ من
الحكومات قد لا يهتم وقد لا يحرص وقد لا يجتهد في إقامة المُمْكِن من الشريعة، فيكون
آثما بما قَصَّرَ فيه، لكن لا يكون كافِرًا، لأنه يؤصل تحكيم الشرع؛ فلا يصلح أبدًا أن
يُعَمَّم الحكمُ بتكفيرِ من أطاعَه أو نَصَرَه كما تفعل جماعات التكفير.
ثم لابد أن نفرق
بين أمر مُحارَبَة الإسلام وبين مُحارَبَة جماعة منتمية إلى العمل الإسلامي، فإن هذا من أخطر مسائل الانحراف.
كثيرٌ من الجماعات
تجعلُ من يُقاتِلها أو يُخَالِفها أو يُحارِبها مُحَارِبًا للإسلام، وتُعَامِلُه على
ذلك مُعامَلَة الكفار والمشركين المرتدين، وهذ من أخطر الأمور؛ فإنه ليس كل من خالَفَ طائفةً من المسلمين مُحارِبًا
للإسلام، ولو كان من شَرِّ أهلِ البدع، حتى يأتي من ذلك أمرًا لا مَرَدَّ له،
والله المستعان.
ومن هنا تعلم
أن قول الجماعات التكفيرية -التي تُقاتِل الجيوش العربية والإسلامية في معظم الدول
العربية- من أن كل من انتمى إلى هذه الجيوش ولَبِسَ الملابس العسكرية، أو الشرطة، أو
المصالح الحكومية الحاكِمَة، فإنه قد خرج من المِلَّة وارتد عن الإسلام، بفهمهم الخاطِئ
لقضية المُوالاة والنُّصْرَة؛ أن هذا القولَ خارِجٌ عن عقيدة أهل السُنَّة والجماعة،
وأنه غُلُوٌ في التكفير دون تَثَبُّتٍ.
وقد دَلَّ القرآن العظيم على أن وجود الإنسان في طائفة
غير مُسْلِمَةٍ لا يَلْزَمُ من ذلك كُفْره، قال الله -عزَّ وجلَّ-: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن
يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن
كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ
ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ
إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا"؛
فدَلَّت الآية على أن مجرد الانتماء إلى طائفةٍ كافِرَةٍ لا يَلْزَمُ منه أن يكون الشخص
كافِرًا.
وكذلك تَرْكُ
نُصْرَةِ طائفةٍ مُسْلِمَةٍ في مواجهتها لطائفةٍ كافرةٍ جَعَلَه كثيرٌ من الجماعات
المُنحَرِفَة سببًا لتكفير من لم ينصرهم، وهذا خللٌ كبيرٌ، وخلافُ نَصِّ كتابِ اللهِ -عزَّ وجَلَّ-،
وخلافُ ما كان من سُنَّةِ النبي -صلى الله عليه وسلم-.
قال الله -عزَّ وجَلَّ-:
"وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ
حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۚ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ
إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ
تَكُن فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ"..
ومع أن هذه الآية صريحة في
أمر المُوالاة، وأن أيَّ طائفةٍ مُسْلِمَةٍ تستنصر بطائفةٍ مُسْلِمَةٍ أخرى في قتالها
مع طائفةٍ كافرة يلزمهم النصر -إذا كان القتال على الدين- وتلزم النُّصْرَة في الدين،
لكن إذا كان هناك بين الطائفة المؤمنة أو الدولة المسلمة وبين الطائفة المُحَاِربة
لطائفةٍ أخرى عهدٌ وميثاقٌ وصُلْحٌ وهُدْنَةٌ فلا يجوز أن ينقضوا عَهدَهم بمُناصَرَة
الطائفةِ المُسْلِمَةِ التي تقاتل هذه الطائفةَ الكافِرَة؛ فوصف الحَرْبِيَّة وصفٌ نسبيٌ، وقد يكون وصفًا لطائفةٍ كافِرَةٍ
مع طائفة مُسْلِمَةٍ، ولا يكون هذا الوصف هو ذاته نفس الوصف مع طائفةٍ أخرى، يمكن أن
يكون هؤلاء الكفار مُعَاهدين مع طائفةٍ ومُحَارِبين لطائفةٍ.
وقد كان "أبو بصير" داخل حدود المدينة مُلْزَمًا بعهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قريش، ولذلك رَدَّهُ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إلى المشركين
كما اشترط المشركون في الحديبية، فلما خرج -رضي الله عنه- إلى خارج حدود المدينة صار المشركون
حربيين بالنسبة له، وتمَكَّنَ من قتلِ واحدٍ منهم، وهم يريدون أَسْرَه وتعذيبَه
وفتنتَه عن الإسلام، ولما ابتعد عن حدود دولة المدينة جازَ له ما لم يَجُز للمسلمين
من قريش بحُكم العهد الذي بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبينهم، ولم يكن ذلك مع "أبي
بصير" وطائفته.
ودَلَّ ذلك على
أنه لا يلزم لكلِّ دولةٍ مُسْلِمَةٍ أن تَنصُرَ دولةً أخرى وقَعَت في مواجهةٍ عسكريةٍ
مع دولةٍ أو جماعة كافِرَةٍ -أن تقوم بنُصْرَتِها- عسكريًا إذا كان بينها وبين الدولةِ
أو الطائفةِ المُحَارِبَةِ للمسلمين عهدٌ يلزم الوفاء به. والله أعلى وأعلم.
نستكمل في مقال قادم إن شاء الله.