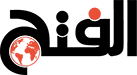الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فإن المؤمن لا يَعرف الوهن والخور، ولا يتغلب على قلبه اليأس والقنوط؛ إنه يوقن أن العاقبة للمتقين، ويؤمن بقوله -تعالى-: (وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) (الروم:47).
ويعلم المؤمن أنه لا يُمَكَّن له حتى يُبتلى، لكن طريق النصر قد يتخللـه عقبات تعقبها المسرات، فبعد الضيق الفرج، كما أنه يؤمن بالقدر خيره وشره، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن مع العسر يسرًا، ويعلم أن ما يجري في خلق الله فهو لحكمةٍ بالغةٍ منه -سبحانه-؛ قد نعلم هذه الحكمة، وقد لا نعلمها.
وفي طيات هذه الأحداث والأهوال التي تمر بها أمتنا الإسلامية عمومًا -والبلاد العربية خصوصًا- قد يتسرب اليأس إلى بعض النفوس؛ فأردتُ في هذه الكلمات أن أهمس في أذن إخواني بمعانٍ سامية، خلاصتها: أن الشرَّ الذي يقدره الله يكون في طياته خير حتى لو لم يظهر ذلك لنا؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّ صَلَاتِي، وَنُسُكِي، وَمَحْيَايَ، وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اللهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ).
وقد ذكر الإمام النووي -رحمه الله- في شرح صحيح مسلم (6/85) في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) خمسة أقوال، قال: "والرابع معناه: والشر ليس شرًّا بالنسبة إليك، فإنك خلقته بحكمةٍ بالغة، وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين".
وقال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في شرح رياض الصالحين: "فإذا قال قائل: كيف تجمع بيْن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-: "(وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ) (رواه مسلم)، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ) فنفى أن يكون الشر إليه؟!
فالجواب على هذا أن نقول: إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدًا؛ الشر المحض الذي ليس فيه خير لا حالًا ولا مآلًا، هذا لا يمكن أن يوجد في فعل الله أبدًا، هذا مِن وجه؛ لأنه حتى الشر الذي قدَّره الله شرًّا لابد أن يكون له عاقبة حميدة، ويكون شرًّا على قوم وخيرًا على آخرين، أرأيت لو أنزل الله المطر مطرًا كثيرًا فأغرق زرع إنسان، لكنه نفع الأرض وانتفعت به أمة لكان هذا خيرًا بالنسبة لمَن انتفع به، شرًّا بالنسبة لمَن تضرر به، فهو خير مِن وجه وشر مِن وجه.
ثانيًا: حتى الشر الذي يقدِّره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة؛ لأنه إذا صبر واحتسب الأجر مِن الله نال بذلك أجرًا أكثر بأضعافٍ مضاعفة مما ناله مِن الشر، ولهذا ذُكر عن بعض العابدات أنها أصيبتْ في أصبعها أو يدها فانجرحت فصبرت وشكرت الله على هذا وقالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. ثم نقول: إن الشر حقيقة ليس في فعل الله نفسه، بل في مفعولاته، فالمفعولات هي التي فيها خير وشر، أما الفعل نفسه فهو خير، ولهذا قال الله -عز وجل-: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ . مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ) (الفلق:1-2)، أي: مِن شر الذي خلقه الله".
وقد قال ابن القيم -رحمه الله-: "ومما ينبغي أن يُعلم: أن الرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد، وإن كرهتها نفسه وشقت عليها؛ فهذه هي الرحمة الحقيقية فأرحم الناس بك مَن شق عليك في إيصال مصالحك ودفع المضار عنك. فمِن رحمة الأب بولده: أن يكرهه على التأدب بالعلم والعمل، ويشق عليه في ذلك بالضرب وغيره، ويمنعه شهواته التي تعود بضرره، ومتى أهمل ذلك مِن ولده كان لقلة رحمته به، وإن ظن أنه يرحمه ويرفهه ويريحه؛ فهذه رحمة مقرونة بجهلٍ كرحمة الأم.
ولهذا كان مِن تمام رحمة أرحم الراحمين: تسليط أنواع البلاء على العبد؛ فإنه أعلم بمصلحته، فابتلاؤه له وامتحانه ومنعُه مِن كثيرٍ مِن أغراضه وشهواته مِن رحمته به، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه، ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه!
وقد جاء في الأثر: إن المبتلى إذا دعي له: "اللهم ارحمه" يقول الله -سبحانه-: كيف أرحمه مِن شيء به أرحمه؟! وفي أثر آخر: "إن الله إذا أحب عبده حماه الدنيا وطيباتها وشهواتها كما يحمي أحدكم مريضه"؛ فهذا مِن تمام رحمته به لا مِن بخله عليه؛ كيف وهو الجواد الماجد الذي له الجود كله، وجود جميع الخلائق في جنب جوده أقل مِن ذرة في جبال الدنيا ورمالها!
فمِن رحمته -سبحانه- بعباده: ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي رحمة وحِمْية، لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغني الحميد، ولا بخلًا منه عليهم بما نهاهم عنه؛ فهو الجواد الكريم.
ومِن رحمته: أن نغص عليهم الدنيا وكدَّرها؛ لئلا يسكنوا إليها، ولا يطمئنوا إليها، ويرغبوا في النعيم المقيم في داره وجواره، فساقهم إلى ذلك بسياط الابتلاء والامتحان، فمنعهم ليعطيهم، وابتلاهم ليعافيهم، وأماتهم ليحييهم!" (إغاثة اللهفان).
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "لما كان منصب الخُلة منصب وهو منصب لا يقبل المزاحمة بغير المحبوب، وأخَذَ الولد شعبةً مِن شعاب القلب؛ غار الحبيب على خليله أن يسكن غيره في شعبة مِن شعاب قلبه؛ فأمره بذبحه، فلما أسلم للامتثال خرجتْ تلك المزاحمة وخلصت المحبة لأهلها؛ فجاءته البشرى (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ) (الصافات:107)، ليس المراد أن يعذب ولكن يبتلى ليهذب" (بدائع الفوائد).
هذا، وللمتنبي بيت شعر صار مثلًا، فيه شيء مِن هذا المعنى، قال:
لعـل عـتـبـك محمود عـواقـبه فربما صحت الأجسام بالعلل!
قال الواحدي في "شرح ديوان المتنبي": "يقول: لعلي أحمد عاقبة عتبك، وذلك أن أتأدب بعد عفوك فلا أعود إلى شيءٍ أستوجب به العتب كمَن يعتلُّ، فربما تكون علته أمانًا له مِن أدواء غيرها فيصح جسمه بعلته مما هو أصعب منه".
وللحديث بقية -إن شاء الله-.
سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.