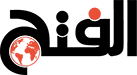الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
أولًا: مثال يوضِّح أين تكمن المشكلة؟
إذا كنتَ في القاهرة،
وسألك رجلٌ لم يسافر قط بسيارته إلى الإسكندرية أن تصف له الطريق، فأنت تحتاج إلى
جهدٍ كبيرٍ، ربما لتثبت له أن الطريق الفلاني هو أفضل الطرق ثم تصف له الطريق
تفصيليًّا، ولكن: هل يليق أن تتصرف بذات الطريقة إذا كنت سائرًا على الطريق والسيارة
التي بجوارك على ذات الطريق ومتجهة إلى ذات الاتجاه قد حصل لقائدها شك أو تردد في إحدى
مفارق الطريق، واسترشدك بشأنه؟!
فهل يليق أن تطلب
منه أنه طالما قد شك في هذه الجزئية فليرجع حتى يكون في أول الطريق ثم يتأكد مِن
أن هدفه هو الذهاب إلى الإسكندرية، وأن هذا الطريق يؤدي بالفعل إليها، و ... ؟!
أو هل -على الأقل-
تطالبه أن يقف ثم يخادع نفسه أنه غير واثق مِن شيء، وأنه الآن في مكانٍ ما مِن
الكرة الأرضية، وعليه أن يبرهن لنفسه أنه بالفعل في الطريق إلى الإسكندرية، وأنه
الآن في نقطة كذا ... ؟!
ثم إن
بعض هؤلاء: بعد أن يجعلك تتوقف ثم تشكك نفسك أو تخادعها، ثم تعيد تصور الطريق، يطلب
منك أن تخدع نفسك ثانية؛ لتتوهم أنك الآن على يقين مما أنت عليه، ومِن ثَمَّ فأنت
مستعد لتسمع منه جواب ما أشكل عليك!
والبعض
الآخر:
سيكون صريحًا مع نفسه أكثر، ويكتشف أن الشك الذي طالبك أن تلقيه في قلبك ليس له مِن
علاج، فسيطالبك بأن تتضرع إلى الله، وتتنظر انشراح صدر يزيل عنك الشك الذي جلبته
لنفسك!
ولا شك
أن العاقل هو: مَن سيدرك أنه بالفعل على الطريق، وأنه غير شاكٍ، ولا متردد فيما مضى من
الطريق، وأن عليه أن يزيل عنه اللبس في الجزئية اليسيرة التي أمامه.
وهذا
المثل مضروب للمتكلمين مِن: "الأشاعرة، والماتريدية، والصوفية" في مقابلة
طريقة السلف -رضي الله عنهم-، فمِن هؤلاء: مَن يكلفك أن تشكك نفسك فيما أنت
مستيقن منه مِن: وجود الله ووحدانيته، وصدق رسوله -صلى الله عليه وسلم-. ومنهم مَن
يخجل مِن أن يطالب المؤمن بشكٍّ فيدَّعي أنه إنما يطلب منه أن يفكر كما لو كان
شاكًّا دون أن يشك بالفعل! وهذا بلا شك فتح لحصون القلب أمام شيطان الشكوك.
ومنهم مَن
أدرك: أن
مسالك المتكلمين التي تطالب المتيقنين أن يشككوا أنفسهم لكي ينالوا يقينًا خاصًّا
عن طريقها هي ذاتها أضعف مِن أن توصف باليقين، حتى يمكن أن تكون وسيلة للوصول إلى
اليقين في غيرها، فطالب الناس أن يسلكوا تجارب روحية "ولأنه سيتعلمها كطريقة لإثبات
صدق الوحي" فلن يشترط موافقتها له؛ مما يعنى أننا في النهاية جعلنا ممارسات
غير مأثورة وغير معقولة، حاكمة على الأثر، وحاكمة على العقل!
ومن عجيب
الأمر:
أن غلو المتكلمين في إعمال العقل والمنطق والبرهان كما زعموا قادهم إلى الخرافة
تحت مسمَّى التجربة الروحية، وأخرجوها عن سلطان الشرع والعقل، ومِن هنا كان الجمع
العجيب بين عقائد المتكلمين، وخرافات الصوفيين!
ثم إن كثيرًا مِن
هؤلاء وفَّقه الله إلى أن يتعلَّم الفقه على أيدي المدارس السُّنية "لا سيما الأئمة
الأربعة وتلامذتهم"؛ إلا أنه حتى في هذا الجانب من جوانب الديانة لم يسلِّم
لهم، فهم مع غلوهم في علم الكلام كعلم عقلي إلا أن آثاره من الشك والحيرة جعلت بعض
نُظَّارهم: "كالإمام الغزالي"، يقضى بحرمة تعليم هذا العلم للعوام، كما في
كتابه: "إلجام العوام عن علم الكلام".
وقصور
علم الكلام دفعهم إلى قبول التجارب الصوفية بغير دليل: فأصبحوا مخاصمين للدليل في
دراستهم العقدية، وفي تجاربهم الروحية، ثم نقلوا تلك الكراهية للدليل إلى دراستهم
للفقه؛ رغم الالتزام بسنيتها، فمنهم مَن حرَّم النظر في الأدلة، ومنهم مَن نادى
بغلق باب الاجتهاد، ثم رتَّب على هذا: أن الأدلة مِن الكتاب والسنة صارت غير ذات
فائدة! ومنهم مَن تلطَّف وقال: أدلة الكتاب والسنة تُذْكَر تبركًا، ومِن ثَمَّ
نادوا بالتقليد وعابوا على مَن يتبع الدليل أنه خارج عن فقه الأئمة، مع أنهم إنما
يدرس فقههم بأدلته.
ومناقشة
هذا المنهج بشعبه الثلاث: "العقيدة الكلامية - والسلوك الصوفي - والتقليد المذهبي"
أمره يطول؛ إلا أن المقصود هنا مناقشة إحدى سقطاته الكبرى، وهي دعوتهم إلى الشك في
العقائد، حتى وإن غلَّف بعضهم طلب الشك وحاول أن يجمله، ففرق بين الشك الحقيقي والشك
المنهجي على ما سبقت الإشارة إليه في المثال -ويأتي تفصيل له بإذن الله في باقي
المقال-.
وفي الجزء الثاني -إن شاء الله- سنبيِّن المسلك القرآني
في أمرين:
الأول: في إقامة الحجة على
المخالفين.
الثاني: تعزيز اليقين لدى
المؤمنين.
ومِن ثَمَّ سيتضح بُعد
هؤلاء المتكلمين أيما بعدٍ عن نور الكتاب والسنة.
أولًا: آفة الفلسفة وعلم الكلام النظر إلى الدنيا
الواسعة مِن نافذة رياضية ضيِّقة:
الآفة الكبرى لدى
الفلاسفة، والتي ورثها عنهم مَن سُمُّوا بفلاسفة الإسلام، ثم ورثتها عنهم الفِرَق
الكلامية هي: أنهم تأملوا فوجدوا أن الرياضيات تستنِد إلى مقدماتٍ قطعيةٍ، وطُرق
برهان قطعية، فينتقل المتعلِّم لها بين يقينيات لا تقبل الشك، ولا الجدل، فظنوا
جهلًا منهم: أن القضية في النموذج الرياضي، وأننا متى وضعنا اللغة الحية في قوالب
رياضية سنصل إلى اليقين الذي لا يتطرق إليه شك في كل القضايا!
ومِن ثَمَّ
اختزلوا اللغات بثرائها في عِدَّة قواعد للاستنباط، بينما اللغات "لا سيما
اللغة العربية" تتضمن قاموسًا واسعًا للمفردات، وهذه المفردات يَرِد عليها: الاشتراك، ويرد
عليها استعمالات مشهورة، وأخرى أقل شهرة، ومعانٍ لا تُرَاد إلا مع قرائن، ويرد
عليها العموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، كما أن الأساليب تتنوع، ولكل جملة
منطوقها، وقد يدل الدليل على أن القائل يقصد أيضًا إلى مفهومها، وكل هذه الأمور يُحتَاج
في تفسيرها إلى معرفة: "السياق، والسباق، واللحاق"؛ مما يعني: أن كلام
المخلوقين؛ فضلًا عن كلام الخالق لا يمكن فهمه بطريقة آلية، بل لا بد من عملٍ عقليٍ
في كلِّ نصٍّ على حِدَة استصحابًا لهذه المعاني السابقة.
وليس أدل
على ذلك مِن: فشل برامج الترجمة الآلية؛ رغم أنها تُغذَّى بكل القواميس المتاحة، وبأنماط
الاستعمالات المختلفة لكلِّ كلمة، ومع هذا تأتي في كثيرٍ مِن الأحيان بالترجمات المضحكة
لبعض النصوص، ثم إن القضية ليستْ في فَهْم نصوص بقدر ما هو في تكوين معرفي بقضايا
معينة لا يملك فيها الإنسان إلا حواسه، وقد دَلَّ الدليل على أنها محدودة، وفي كل
يوم يكتشف الإنسان مدى جديدًا للرؤية، ومدى جديدًا للسمع، بما مَنَّ الله به عليه
مِن اكتشاف آلات توسِّع مدى هذه الحواس، وبالقطع ستبقى أمورٌ كثيرةٌ غائبة عن عِلْم
البشرية ككلٍّ إلى أن يرث الله الأرض ومَن عليها: (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا
قَلِيلًا) (الإسراء:
85).
ثانيًا: مِن أكبر أخطاء المتكلمين ظنهم أنه يلزمهم
صياغة حججهم على صحة الإسلام على طريقة الفلاسفة:
كان طريق دخول
المسلمين إلى الفلسفة والمنطق ثم إلى تأسيس علم عقيدة جديد غير الذي عرفه السلف يُسَمَّى
علم الكلام عن طريق الجدل، ومناظرة الديانات ذات الطابع الفلسفي، بينما جاء القرآن
بالأدلة العقلية التي تقيم الحجج على مَن يقرُّ بالنبوات ويجحد نبوة محمدٍ -صلى
الله عليه وسلم- مِن أهل الكتاب، ومجادلة الذين ينكرون البعث من مشركي قريش وغيرهم،
وأمر الله -عز وجل- نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يستعمل هذه الحجج القرآنية في
دعوة أصناف الكفار، وقال -تعالى-: (وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا) (الفرقان: 52)، وعد ذلك الجدل مِن الجدل
المذموم: (وَلَا تُجَادِلُوا
أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (العنكبوت: 46).
وأصول عقائد الفِرَق
الفلسفية لا تخرج عن هذا؛ إلا أن الفلاسفة والمتكلمين وقعوا في خطأٍ فاحشٍ حينما
ظنوا أن البرهان لا يكون برهانًا إلا إذا سيق على ذات قوالب الفلاسفة -وقد قدَّمنا:
أن آفة الفلاسفة هي قوالبهم-.
ومما أوقعهم
في هذا الخطأ: ظنهم أن المناظرة لا بد أن تنتهي بالإفحام لكي تكون قد نصرت الحق، والخصم
لن يُفحَم إلا أن تسوق أدلتك بالطريقة التي يظنها دليلًا! مع أن ما ذُكِر في القرآن
مِن احتجاجات على الدهرية، وعلى نفاة البعث استنادًا إلى مقدمات فطرية، وما بُنيت
عليها من نتائج، لا بد لكلِّ عقلٍ سليمٍ أن يسلِّم بها، ومن أعرض عن الحق ولزم
المراء، طلب الشرع الإعراض عنه وعدم الاستجابة لجدله، قال -تعالى-: (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ
إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا
آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا
وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ) (العنكبوت: 46).
وحتى لو
غلب على الظن أنهم لشدة الفهم للباطل عميت بصائرهم عن رؤية الحق، وأردنا أن نخطو
معهم خطوة أخرى؛ فقد أتى الشرع بالمباهلة لتكون علامة حسية يلجأ إليها المسلمون لإقامة
الحجة على مخالفيهم، والمبالغة في نصحهم، ومحاولة إخراجهم من الظلمات إلى النور،
فمَن أبى بعد ذلك فلا يهلك على الله إلا هالك، قال الله -تعالى-: (فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا
وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ
اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ) (آل عمران:61).
ثالثًا: مِن أكبر أخطاء المتكلمين إلزامهم جميع
المكلفين أن ينزِّلوا أنفسهم منزلة الملاحدة:
فلاسفة اليونان غلب
عليهم الإلحاد والقول بقِدَم العالم، وأنه لا خالق! وهذا نتيجة طبيعية لإنكار صوت
الفطرة -كما سيأتي مع البُعد عن آثار النبوة، والاكتفاء بالدليل العقلي-، فلما فقدوا
-مِن وجهة نظرهم- الدليل العقلي على وجود الخالق، التزموا القول المناقِض للعقل أيما
مناقضة، وهو القول: بأن هذا الكون البديع وُجِد بلا خالق!
فلما وَجَدَ
مَن اشتغل بالفلسفة مِن المنتسِبين إلى الإسلام مدارسَ فلسفية تثبت وجود الخالق،
هرعوا إليها واحتفلوا بها، وإن كان هذا لا يخرجها عن الإلحاد في دين الله، فعامة
الفلاسفة منكِرون للنبوات حتى مَن قال منهم: إن للكون خالقًا.
والتقط المتكلِّمون
الخيط مِن الفلاسفة، وظنوا أن ميدان الجهاد الأكبر هو إثبات وجود الله -تعالى- حتى
إن كُتُب عقائد المتكلمين لا تكاد تعالِج إلا قضية إثبات الربوبية، ولا ينشغلون بإثبات
الألوهية؛ لا سيما مع اللوثة الصوفية التي أصابتهم، وما فيها مِن انحرافاتٍ في
قضية الألوهية.
وبالطبع تعنى كتب
المتكلمين بالأسماء والصفات كفرعٍ على إثبات وجود الله -تعالى-، وأيضًا بلوثة
فلسلفية جعلتهم يتوهمون أن إثبات الصفات ينافي أزلية الله -عز وجل-، أو ينافي
تنزهه عن مشابهة خلقه، وهو أمر خارج نطاق موضوعنا في هذه المقالة.
الخلاصة: أن المتكلمين بنوا
بنيانهم على أن أهم مقاصد الدِّين هو: إقامة العقيدة، وأن أهم مقاصدها هو: إثبات
وجود الرب -جل وعلا-، وأن إثبات وجوده لا بد وأن يأتي به كل مكلَّف مبتدئًا مِن
الشك الذي هو وقوف موقف المحايد من هذه القضية (هل للكون خالق أم لا؟)، وأن يقتل في
نفسه أي درجةٍ مِن درجات الميل إلى إحدى الإجابتين، ثم ينطلق مستدلًا بالقوالب
المنطقية على أن للكون خالقًا، وحينئذٍ يتنفس الصعداء، ويلقي سلاحه؛ فقد بلغ نهاية
السباق! وما درى المسكين: أن هذا الذي يظنه نهاية السباق هي النقطة التي تقف عندها
البشرية جميعًا! وهي النقطة التي يُولَد المولود وهو مقرٌّ بها إقرارًا إذعانيًّا؛
إلا أن الشياطين تعبث بعقول البعض، فإذا بالمتكلمين ينشغلون بهذه الشرذمة الصغيرة
عن سائر البشرية!
وأقبح من
هذا: أن
يطالبوا مَن مَنَّ الله عليه بسلامة الفطرة، بل مَن مَنَّ الله عليه بالإسلام منذ نعومة
أظفاره أن يسعى الى أن يكون حاله كحال هؤلاء!
ومِن ثَمَّ
ادَّعى الأشاعرة: أن أول واجب على المكلَّف هو الشك في أمر الربوبية، ثم لما وجد بعضهم أن
هذا الأمر شديد الفحش، قالوا: نريد الشك المنهجي لا الشك الحقيقي، وهو أن يفكر كما
لو كان شاكًّا، ثم أرادوا التجمُّل أكثر، فقالوا: بل أول واجب على المكلَّف هو النظر
أو الاستدلال.
وبمقدار ما
في هذا العبارات مِن اختلافٍ تُدَار عليه معارك كلامية بين أبناء المذهب الواحد؛ إلا
أنها تشترك في النهاية في معنى واحد فاسد، وهو: أن المسلم الموقن بالإسلام، وصدق
القرآن والسُّنَّة؛ عليه أن يشك أو يتصرف كالشاك، ثم يتعلم أمورًا هي الأخرى ليست
مِن بديهيات العقول، ولا من الشرع المنزَّل، ولا هي مُسَلَّم بها عند أهلها من
معرفة العَرَض، والجوهر، وواجب الوجوب، وممكن الوجود، ومستحيل الوجود؛ لكي يستعمل
تلك العبارات الركيكة في إثبات وجود الرب -تبارك وتعالى-.
ولأن مَن
سيأخذونهم مِن عوام المسلمين مِن يقينهم الفطري إلى هذا الشك يعجز كثيرٌ منهم عن
معرفة تلك العبارات الركيكة؛ فضلًا أن تأخذه مِن شكه الذي أدخلوه عليه فتعيده إلى
يقينه الأول؛ فقد اخترع الإمام الغزالي لهم في كتابه: "المنقذ من الضلال"
الرجوع إلى التريبة الروحية لكي يصل إلى اليقين، وهو -كما أسلفنا- تريبة روحية
متحررة من قيود العقل، ومن اتباع الشرع؛ بيد أنها بالفعل كانت علاجًا للغزالي، وقد
تكون علاجًا لغيره بمقدار ما فيها مِن تضرُّع إلى الله وصدق اللجوء إليه، والافتقار
له بطلب الهداية حتى ولو كانت على طريقة مبتدعة.
فلم تكن تلك الطرق هي
سبب الهداية، وإنما اليقين الذي حاولوا كتمه في قلوبهم، والإيمان بوجود الخالق، وبأنه
يهدي مَن يشاء إلى ما اختلفوا فيه من الحق بإذنه هو الذي كان سببًا في هداية مَن
عاد مِن هؤلاء مِن رحلة ضلاله، وهو ما أدركه الغزالي في آخر حياته، وإن لم يطل
االله في أجله حتى يدوِّن لنا رحلته الخيرة إلى اليقين الحقيقي حينما مات وصحيح البخاري
على صدره! وهو مصير رحم الله به كثيرًا ممَّن طوَّفوا في تلك المتاهات، وكتموا إيمانهم
الحقيقي في قلوبهم، وستروه بشبهات أوردوها عليه عمدًا طلبيًّا؛ لما ظنوه أنه برهان،
فلما رقدوا في فراش المرض وجدوا أنه لا سبيل إلا ذلك الإيمان الراسخ؛ فطرة وعقلًا،
بدلالة عقول البشر الطبيعيين، وليس بالمقاييس العقلية المخترعة للفلاسفة والمتكلمين!
قال الرازي
أحد كبار أئمة الأشاعرة -بل إن أثره في المذهب يفوق أثر أبي الحسن الأشعري نفسه-:
نهاية إقدام العقول
عقال
وغاية سعي العالمين
ضلال
وأرواحنا في وحشة من
جسومنا
وحاصل دنيانا أذى
ووبال
ولم نستفد من بحثنا
طول عمرنا
سوى أن جمعنا فيه
قيل وقالوا
فكم قد رأينا في
رجال ودولة
فبادوا جميعًا
مسرعين وزالوا
وكم من جبال قد علت
شرفاتها
رجال فزالوا والجبال
جبال
وقال: "لقد تأملت
الطرق الكلامية، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلًا، ولا تروي غليلًا، ورأيت
أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ
اسْتَوَى) (طه:5)، (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) (فاطر:10). وأقرأ في النفي: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ) (الشورى:11)، (وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا) (طـه:110)، ومَن جَرَّب مثل تجربتي، عرف مثل معرفتي!".