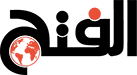الحمد لله، والصلاة
والسلام على رسول الله، أما بعد؛
تمهيد:
يكاد يجمع مَن صنَّف
في تاريخ الفقه الإسلامي أنه يمكن تقسيم الفقهاء الذين دُوِّنت آراؤهم، وكوَّنت ما
عُرِف لاحقًا بمذهب فلان أو فلان، ينقسمون إلى ثلاث مدارس رئيسية، وهي:
- مدرسة أصحاب
الرأي:
وأبرز فقهائها هو: الإمام أبو حنيفة، وهو الوحيد مِن الأئمة الأربعة الذي يُصَنَّف
ضمن هذه المدرسة.
- مدرسة أصحاب
الحديث:
ويمثِّلها مِن الأئمة الأربعة: الأئمة مالك، والشافعي، وأحمد.
- مدرسة أهل
الظاهر:
ويمثِّلها: داود بن علي، وابن حزم الظاهري.
ومدرسة أصحاب الحديث
هنا نعني بها الفقهاء الذين اعتنوا بالأدلة، وصُنِّف الإمام مالك على رأس هذه
المدرسة؛ رغم عنايته بالمصلحة، والعرف، وغيرها من مصادر التشريع المكمِّلة للأربعة:
(الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس)؛ لكونه مِن أوائل مَن جَمَع أحاديث الأحكام في
كتابه: "الموطأ".
وقد عقد ابن القيم
-رحمه الله- في "إعلام الموقعين" فصلًا رائعًا في الفَرْق بين الرأي
المذموم والرأي الممدوح الذي يكون تابعًا للنص لا مصادمًا له، ثم نَقَد الطرفين
المتطرفين: نفاة القياس من جهة، ومدرسة أصحاب الرأي من جهة.
فالأولون: نفوا القياس؛ رغم أن
النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أرشدنا إليه حينما سَأَل عمرُ -رضي الله عنه- عن
القبلة للصائم، فأجابه بما يفهم منه: أن حكمها موجود في النصوص، ولكن ليس بدلالة
لفظية، وإنما بدلالة القياس أو الاشتراك في العلة، فقال له -صلى الله عليه وسلم-: (أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ، وَأَنْتَ صَائِمٌ)
قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، قَالَ: (فَمَهْ؟!) (رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني).
وغيرها من النصوص المثبتة
للقياس، والآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- التي تبيِّن أنهم يلجؤون إلى آرائهم،
ومعرفة الأشباه والنظائر فيما لا نص فيه.
وأما أصحاب
الرأي:
فوصفهم ابن القيم -رحمه الله- بأن جريمتهم أشنع؛ لأنهم عارضوا النصوص بأقيستهم،
فخالفوا الصواب وجرأوا الزنادقة على الطعن في الشريعة.
ويجب هنا أن نقف وقفة مع أصحاب الأهواء، فشتان بين
ثلاثة أصناف من الناس:
الصنف الأول:
الأئمة
الأعلام: كالإمام أبي حنيفة، وهؤلاء يجب أن نرفع عنهم الملام، وكأن ابن تيمية قد
صنَّف رسالته الرائعة: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"؛ للدفاع عن أبي حنيفة
خاصة.
ولم يكن الإمام أبو
حنيفة أو شيوخه أو صاحباه؛ يقدِّمون الرأي على النص، وإنما كانوا في العراق بعيدًا
عن الحجاز حيث حَمَلَة السُّنة، ولم تكن السنة "لا سيما أحاديث الأحكام"
قد جُمِعَت على هذا النحو، ومَن منهم شهد بدايات جمعها على ذلك النحو -كصاحبي أبي
حنيفة- تراجع عن كثيرٍ مِن أقواله التي قالها بالرأي، واكتشف أن فيها نصوصًا تدل
على خلاف ما ذهب إليه برأيه، فضرب كلٌّ منهم برأي نفسه عُرْض الحائط قبل أن يقول
لنا: "إذا رأيتم قولي يُخَالِف قولَ النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ فاضربوا بقولي
عُرْض الحائط".
وأما
الصنف الثاني: وهم الذين انتقدهم الأئمة الأعلام مِن أتباع المذاهب الأربعة؛ فانتقدهم الطحاوي
الحنفي، وابن عبد البر المالكي، وابن حجر الشافعي، وابن تيمية الحنبلي، وهم المقلِّدة
الذين خالفوا نصيحة أئمتهم بطرح آرائهم المخالفة للسُّنة، وبطبيعة الحال كان الأئمة
الذين اشتُهِروا بالرأي قَبْل جَمْع السنة هم أكثر مَن وُجِدت عندهم أقيسة خاطئة،
فاستثقل هؤلاء المقلدة هذا، فدافعوا عن أقوال أئمتهم، ورَدُّوا السنن مِن أجلها
بحججٍ ساقطةٍ!
وأما
الصنف الثالث: فهو مِن أسوا آثار وجود الصنف الثاني؛ فالصنف الثالث "وهم: الزنادقة"
انطلقوا مِن معارضة هؤلاء لأحكامٍ تفصيليةٍ بالأقيسة الفاسدة، ونَسَجوا على ذات
المنوال في القضايا الكلية؛ سواء كانت اعتقادية أو عملية.
وفي
زماننا:
ما زال المستشرقون وأفراخهم من العالمانيين يستعملون نفس الأسلوب؛ رغم أنهم متى
شعروا بنشوة الانتصار دعوا إلى القضاء على الجميع، وإحراق جميع كتب التراث، و ... !
وصنف
رابع أَطَلَّ علينا في هذا الزمان: وهم قومٌ يزعجهم الهجوم المتكرر للغرب على شرائع الإسلام؛
لا سيما في مجال التشريع، وفي مجال الأسرة والعلاقة بين الرجل والمرأة، وحجاب
المرأة المسلمة، وفي مجال التنظيم الاقتصادي، وغيره.
ويُحْسِن هؤلاء الظَّنَّ
بالغرب؛ أننا لو أجرينا تعديلاتٍ على الشريعة، فربما رَاقَتْ لهم، ومِن هنا انتصر
هؤلاء لمدرسة الرأي بالمعنى المذموم، وعارضوا السنن بآرائهم!
وكنوعٍ مِن
التلبيس ادَّعى هؤلاء أنهم في ذلك تبعٌ لأبي حنيفة، بل بلغت الجرأة ببعضهم "وهو:
الشيخ محمد الغزالي -عفا الله عنه-" في كتابه: "السُّنَّة النبوية بين أهل
الفقه وأهل الحديث": أن يتصور أن ثمة حربًا منهجية بين الإمام أبي حنيفة
وبين الأئمة الثلاثة بعده، ووصف الإمام أبا حنيفة بأهل الفقه، ومَن بعده بأهل
الحديث، أو هكذا يُفهم مِن سياق كلامه مِن أوله إلى آخره؛ بيد أن بعض مسائله التي
نَسَبَها إلى الفقهاء وانتقد ما أسمَاه: "مذهب أهل الحديث"، كانت مِن
جملة المجمع عليه أو -على الأقل- مما اتَّفَقَتْ فيه المذاهب الأربعة!
بل إن
بعض الأبواب التي يكثر اللغط حولها، وهي: "الأحوال الشخصية": كان الفقه المالكي
والحنبلي "لا سيما عند مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية" -وهي مدرسة تتميز
بتعظيم النص والعناية بفهم السلف، والاستدلال بمذاهب الصحابة، ولكن في ذات الوقت
تولي عناية خاصة للعلل والمقاصد الشرعية المنصوص عليها، أو المستنبطة مِن الأدلة
الصحيحة-؛ أيسر مذهبًا في أبواب المعاملات في المدارس المنتسِبَة إلى الأئمة الأربعة.
وقد قدَّمنا في المقالات
التي تناولت كتابات الشيخ "محمد أبو زهرة" عن قوانين الأحوال الشخصية
كيف أنه في المدة التي طُبِّق فيها في الأحوال الشخصية مذهب أبي حنيفة -رضي الله عنه-
كان هناك عنت كبير ومشقة حتى تم أخذ بعض الأحكام من مذهب المالكية ثم الحنابلة، وفي
النهاية مِن اجتهادات شيخ الإسلام ابن تيمية.
وعلى أيٍّ؛
فمِن باب: "رفع الملام عن الأئمة الأعلام"، ومن باب الذب عن عرض الإمام أبي
حنيفة، نكتب هذه المقالة لنبيِّن فيها: أن أبا حنيفة -رحمه الله- لم يقدِّم رأيه قط على
الكتاب ولا على سنة بلغته، وأنه بذكائه وحدسه أدرك أنه لا شك قد يكون بعض ما أفتى
فيه برأيه فيه سنن سيطلع عيلها مَن بعده، فأوصى بوصيته الذهبية بترك رأيه إلى
مقتضى أدله الكتاب والسُّنة.
بل إن مالكًا -وهو
ساكن المدينة النبوية المنورة حيث وفرة حاملي السنة، ورغم تصديه لجمعها- لما طَلَب
منه المنصور أن يجمع الناس على كتابه لم يجبه إلى ذلك، وقال: "إن الناس قد
جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها".
قال الإمام
ابن كثير -رحمه الله-: "وذلك مِن تمام علمه واتصافه بالإنصاف".
وقد اعتنى العلامة "أبو
زهرة" في كتبه: "أبو حنيفة"، و"مالك"، و"الشافعي"
بيبان سبب ظهور مدرستي: "الرأي، وأصحاب الحديث"، وكيف اتسعت الفجوة
بينهما قبل عصر الأئمة الأربعة، ثم أخذت تضيق شيئًا فشيئًا على يد أبي حنيفة -رحمه
الله- وتعظيمه للنصوص، ثم على يد مالك -رحمه الله- إلى الحدِّ الذي جَعَل البعض
يصنِّفه كأحد فقهاء مدرسة الرأي، ثم على يد الإمام العظيم الشأن محمد بن إدريس الشافعي
الذي هيَّأ الله له دراسة اللغة حتى صار عَلَمًا فيها، ثم تتلمذ على يد الإمام
مالك حتى صار نابهًا في فقه أصحاب الحديث، ثم رحل إلى الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي
حنيفة، ثم أخرج لنا ذلك كله دررًا لا يمكن أن يختلف عليها اثنان.
ولا أعني
بالطبع اجتهادات الشافعي الفقهية؛ فهو كغيره مِن الأئمة قد أَمَرَنا أن نضرب بالأقوال
التي تخالِف قول النبي -صلى الله عليه وسلم- عُرْض الحائط، وهو القائل: "إذا صَحَّ الحديث؛
فهو مذهبي"، ولكن أعني دُرَّة مؤلفاته -رحمه الله-، ودرة مؤلفات التراث الإسلامي،
وهو: "كتاب الرسالة"، حيث بيَّن الاحتجاج بالكتاب والسُّنة، ورَدَّ على
متعصبة أصحاب الرأي الذين يرفضون العمل بحديث الآحاد، وانتصر للقياس وبيَّن حُجِّيَّتَه،
ومع هذا أيضًا وَضَّح ضوابطه حتى لا يكون عملًا بهوى أو مصادمة للنصوص.
ولستُ
بصدد بيان فضل كتاب: "الرسالة"، وإنما أريد أن ألخِّص لكَ ما ذكره
العلامة "محمد أبو زهرة" حول هذه القضية، وهو يُرجِع الخلاف بين مدرستي:
"الرأي والحديث" إلى عاملين رئيسيين:
الأول: كيفية مواجهة الأحاديث
المكذوبة والموضوعة، ودخول غير المؤهلين لحلبة رواية الحديث، ومِن ثَمَّ رأى البعض
أن يعمل بالأحاديث التي لا غبار عليها ألبتة، ويكمل هذا بالرأي، والبعض رأى أن
الحلَّ هو التمحيص في أحوال الرواة، وتمهيد القواعد التي يمكن بها أن نطمئن أو لا
نطمئن إلى صحة ما يُنْسَب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- من أخبار.
الثاني: إذا كانت النصوص
محدودة، ووقائع الناس لا تنحصر؛ فهل يتصدَّى المجتهد لما وقع مِن المسائل فقط تاركًا
باقي المسائل المحتملة إلى أن تقع أم أنه يجمل به إذا كانت عنده آلة النظر أن يفرِّع
المسائل لمَن بعده؟
ومِن ثَمَّ تصدَّى أصحاب
الرأي لبحث مسائل أكثر مِن التي تصدَّى لها أصحاب الحديث.
ومِن ثَمَّ أيضًا؛
فقد ظَهَر أن نسبة ملموسة منها مخالفة للنصوص بعد أن تم جَمْعُ
السُّنة.
وغني عن
الذكر:
أنه لولا التقليد الأعمى لتكاملت المدرستان وتطابقت أصولهما الكلية، وإن كان ولا بد
أن تبقى مساحة من الاختلاف كتلك التي وَقَعَت لمَن كانوا في زمنٍ واحدٍ، وخوطبوا
بخطابٍ واحدٍ، واختلفوا في فهمه كما في حديث: (لَا
يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ) (متفق عليه).
وذلك أن قواعد تمحيص الأخبار قد اكتملت، وأن السنة
قد جُمِعَت، وأن أحوال الناس قد تفرَّعت، ومعظم المسائل التي افترضها أصحاب الرأي صارت
واقعًا، وقد استفاد مالك ومِن بعده الشافعي -رحمها الله تعالى- مِن تصوير الإمام أبي
حنيفة -رحمه الله- لتلك المسائل، وإن كانا نظرا فيها مِن واقع ما وصل إليهما مِن أخبارٍ.
الخلاصة:
إن الإمام أبا حنيفة
-رحمه الله- لم يكن يمثِّل مدرسة الرأي المذمومة، بل وإن مدرسة الرأي المذموم فقهيًّا
لا تتساوى بمدرسة الإعراض عن الشريعة، والطعن في أحكامها، وإن كان منهم مَن يقود
الآن مدرسة التلفيق بين الشريعة وبين الأطروحات الغربية.
كان هذا التمهيد والتوضيح
مع عرضٍ موجزٍ لتصور "العلامة أبو زهرة" عن الموضوع.
وفي العدد القادم -إن
شاء الله- نعرض ملخصًا لكلامه -رحمه الله- مِن خلال كُتُبِه التي كَتَبَها عن كلِّ
إمامٍ مِن الأئمة الأربعة.