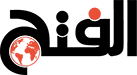الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول
الله، أما بعد؛
فقال الله -تعالى-: (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ
أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وَكَذَلِكَ
نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ
الْمُوقِنِينَ . فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا
رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ . فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ
بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي
لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ . فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً
قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي
بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . وَحَاجَّهُ
قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا
تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ
عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ . وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا
تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ
سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
. الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ
الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ . وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ
عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)
(الأنعام: 74-83).
قوله -تعالى- عن إبراهيم -عليه السلام-: (إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ)، فيه فوائد:
الفائدة الثانية:
استدل إبراهيم -صلى الله عليه وسلم-
على وجوب إفراد القصد والوجهة لله، وهو توحيد الإلهية وتوحيد الله بأفعال العباد
بتوحيد الربوبية؛ توحيد الله بأفعاله -سبحانه-؛ فهو الذي فطر السموات والأرض،
وخلقهما على غير مثال سابق، وهذا الاحتجاج كَثُر في القرآن، قال -تعالى- في أول
أمر وَرَد في ترتيب القرآن: (يَا أَيُّهَا
النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ . الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ
الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ) (البقرة: 21-22).
فذكر وجوب إفراد الله بالعبادة، كما
انفرد -سبحانه- بالخلق والرزق، ونهى عن الشرك بناءً على ذلك.
وقال -تعالى- عن المؤمن في
قصة القرية المذكورة في سورة يس: (وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي
فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ . أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ
يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا
يُنْقِذُونِ . إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ) (يس: 22-24).
فلأنه وحده الذي فطر العباد، وهو الذي
يحيهم ويميتهم، فيجمعهم إليه -سبحانه-؛ فهو وحده المستحق للعبادة، وكيف يستحق غيره
العبادة، وهو لا يملك رفع الضر عن عابده إن أراده الله بضر؟!
وقال -سبحانه وتعالى- في الاستدلال
على وجوب إفراد الله بالعبادة: (أَمْ خُلِقُوا
مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ . أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ . أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ
الْمُصَيْطِرُونَ . أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ
مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ . أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ .
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ . أَمْ عِنْدَهُمُ
الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ . أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا
هُمُ الْمَكِيدُونَ . أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا
يُشْرِكُونَ) (الطور: 35-43).
وهذه الحجة هي أوضح الحجج لدى عامة
الخلق؛ لأن نظرهم يرشدهم قطعًا إلى وجود فاعل واحد لكل هذا العالم؛ صنعه وخلقه،
ودبَّر أمره، ورزق أهله؛ فهو -سبحانه وتعالى- وحده الذي يستحق أن يُعبَد، إذا نظر
العباد إلى ذلك.
ثم هناك حجة أخرى هي أعظم عند أهل
الإيمان، وهي الحنيفية؛ ولذا قال: (حَنِيفًا)، وهذه
هي:
الفائدة الثالثة:
الحنيف هو: المائل إلى الله، المعرض عن غير الله؛
فتضمن ذلك إثبات حب الله -سبحانه-، الذي هو روح العبادة، فالحب والخضوع والذل ركن
العبادة التي لا تصح بدونهم، والعبد إذا وجد قلبه في حب الله -عز وجل- عَرَف حقيقة
الألوهية، كما دَلَّ على ذلك توحيد الربوبية، مثل: ماكينة فيها موضع لترسٍ، إذا وُضِعَت
تروسٌ أخرى تكسرت الماكينة، وتكسرت التروس؛ فإذا وَضَع صاحبُها الترس الذي وَجد
مقاسه مناسبًا، فدارت الماكينة وأنتجت أحسن إنتاج؛ تيقَّن يقينًا أعظم من القياسات
التي حسبها قبل ذلك.
فهذه قضية الحنيفية والميل
إلى الله، فالقلب يشقى ويتعس بتوجهه لغير الله، ويطمئن ويسكن، ويجد أعظم اللذة في
عبادته لله -سبحانه وتعالى-.
قال ابن القيم -رحمه الله-: "إن في القلب شعثًا لا يلمه إلا
الإقبال على الله، وعليه وحشه لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه
إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار
منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه، وقضائه ومعانقة
الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده المطلوب،
وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أُعطِي الدنيا وما فيها
لم تُسَد تلك الفاقة أبدًا" (مدارج السالكين بتصرف يسير).
فحاجة القلب في الميل إلى الله -سبحانه
وتعالى- حاجة ضرورية، أعظم من حاجة البدن إلى النَّفَس، وإلى الماء، وإلى الطعام،
فكما يهلك البدن بامتناع النَّفَس والهواء، والطعام والشراب، فكذلك يموت القلب إذا
لم يكن حنيفًا إلى الله -سبحانه وتعالى-، فالميل إلى الله -عز وجل- ضرورة من
ضرورات حياة قلب الإنسان. نسأل الله أن يمن علينا بحياة قلوبنا".
وقال أيضًا -رحمه الله-: "كلُّ حي له إرادة ومحبة وعمل
بحسبه، وكل متحرك؛ فأصل حركته: المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون
حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده، ولهذا
قال -تعالى-: (لَوْ كَانَ فِيهِمَا
آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا) (الأنبياء: 22)، ولم يقل -سبحانه-:
"لما وجدتا ولكانتا معدومتين"، ولا قال: "لعدمتا"؛ إذ هو -سبحانه-
قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكونا على وجه الصلاح
والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما، فلو
كان في العالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر
والعلو عليه وتفرده دونه بإلهيته؛ إذ الشركة نقص في كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه
أن يكون إلهًا ناقصًا، فإذا قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده والمقهور ليس بإله،
وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون
فوقهم إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق، وطلب كل منهما العلو
على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيها" (الداء
والدواء).
وللحديث بقية -إن شاء الله-.